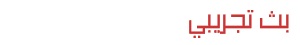قال الدكتور عمار علي حسن، الباحث في العلوم السياسية والاجتماعية، إن “تعليمات قد صدرت إلى كل الصحف، بعد نشر أي مادة رأي تنتقد قرار رفع الدعم عن الوقود، وتبين تأثيره على حال الناس، اللهم إلا كانت تمدح القرار”.
ونشر عمار، مقاله الذي قال أنه ” لم يجد مكانا في أي صحيفة”.
يذكر أن حكومة المهندس مصطفى مدبولي، قررت قبل أيام، زيادة أسعار المحروقات بنسب تتراوح من 17.5% إلى 50%، ضمن سياسة تقليص الدعم.
وإلى نص المقال الذي جاء بعنوان:
أسعار تشتعل ودولة لا تحمي ولا ترحم وطبقة وسطى تنهار
قاد التخلي التدريجي عن تقديم الدعم، استجابة من الحكومة لشروط صندوق النقد الدولي، إلى ارتفاع أسعار مختلف السلع، في بلد تتدني فيه أغلب الرواتب والأجور والدخول إلى مستوى يثير الشفقة، الأمر الذي يعني إلقاء مزيد من الناس تحت خط الفقر الذي بات يضج بالزحام، فاتحا ذراعيه لاستقبال المزيد ممن كانوا من مساتير الناس أو طبقتهم الوسطى في سالف الأيام.
وتقول السلطة إنها لا تجد خيارا أمامها سوى الاستجابة لشروط الصندوق، متغافلة عن أنه تسبب من قبل في تخريب بلدان عدة، وشهد بعض خبرائه في كتب نُشرت وتُرجمت إلى كل اللغات الأساسية في العالم، بأنه لا يملك حلا سحريا لمشكلات البلدان المتعثرة اقتصاديا، وأن بعض من تمردوا على تعليماته القاسية نجوا ببلادهم من مخالبه الجارحة. كما تتغافل السلطة أيضا عن سؤال، لا أعتقد أن البرلمان وجهه إليها، وهو: من الذي حشرنا في الزاوية بحيث لم يعد أمامنا سوى خيار واحد؟ أين الأموال التي قدمت لمصر بعد 30 يونيو 2013 من دول خليجية، وهي لو أُنفقت في مكانها الصحيح لأغنتنا عن الصندوق وشروطه؟ وهل ما يتم اقتراضه من الصندوق يذهب إلى الاستثمار في مشروعات ستجعل اقتصادنا المريض يتعافى أم ستتبخر على غرار سابقتها؟ وفي الأساس: هل يمكن أن ينهض اقتصاد لا يقوده سوى سماسرة الأراضي والمباني؟
وإن جئنا إلى ارتفاع الأسعار بعد رفع جزء من الدعم عن الوقود فما يزيد الطين بلة أن السلطة لا تنض بما عليها من واجب في سبيل حماية المحكومين من عسف التجار والمتحكمين في النقل وفارضي الإتاوات والجبايات في الشوارع، بل إن ممثلي الحكم من بعض رجال الأمن والجهاز البيروقراطي والمكلفين بالتنظيم والضبط يتواطئون مع من يسرقون الناس، بلا ورع ولا روية ولا خوف من حساب أو عقاب، مقابل أن ينال ممثلي الدولة جزءا من المنافع الجمة التي يجنيها المتربحون برفع الأسعار كيفما شاءوا، متخطين الحدود النظرية والشفهية التي تضعها السلطة، وتظن أن دورها انتهى بمجرد الحديث عن تحديد أسعار بعض السلع، ومراقبة السوق، واقفة عند القول لا تتعداه إلى الفعل.
ويزداد الأمر سوءا في ظل تعطل المعادلة المتعارف عليها في العالم كله وهي “الضريبة في مقابل الخدمة” و”الضريبة في مقابل المشاركة في القرار” فقدرة الدولة على تقديم الخدمات تتراجع، وكثير من الأموال التي تُجمع من حصيلة الضرائب لا تذهب إلى ما يخفف عن الناس معاناتهم في تدبير ما ينفقونه على التعليم والصحة، وإن جرى فهو ضئيل قياسا إلى ما هو مطلوب ومستحق. أما المشاركة فهناك ما لا حصر له من القيود عليها، والسدود التي تحول دون انطلاقها، والحدود التي تمنع كل مواطن من حرية التفكير والتعبير والتدبير.
إن ما يجري يؤدي بالتتابع إلى تآكل الطبقة الوسطى، ثم انهيارها، وفقدان نسبة معتبرة من الشعب استقلالها المادي، وهذا معناه تراجع طلبها على المشاركة السياسية، وعلى مساءلة السلطة وحسابها، ما يزيد من انفرادها بالقرار، فيتفاقم التسلط. لكن الأخطر هو فقدان المجتمع لرمانة ميزانه، وللتيار الضروري الحامل للقيم الإيجابية، وللحلقة الوسيطة التي تحافظ على تماسكه، لاسيما مع اتجاه الأغلبية الكاسحة من الناس إلى البحث عن حلول فردية لمشكلاتهم، على حساب المصلحة العامة، التي هي أولى بالعناية والرعاية.
إن ما حدث ويحدث أكبر من أن يترك بلا حساب أو مساءلة، وليس بوسع عاقل أن ينصت إلى مجموعة من المدلسين يحملون من قاموا متنفضين ضد الفساد والاستبداد ليبنوا دولة مدنية عصرية مسؤولية ما نحن فيه، مع أن أي منصف يجب عليه أن يمد، جردة الحساب، لتقف على الأقل عند حدود 1952، ويقارن بين اقتصادنا قبل هذا العام وبعده، أو يتقدم سنوات، إن شاء، ليقف عند 1974، التي بدأ فيها ما سمى بالانفتاح الاقتصادي، ويقارن بين ما قبلها وبعدها. إنها سلسلة متعاقبة من الفشل، لم يكن سببه اقتصادي بالأساس، إنما سياسي، فحكام مستبدون بلا خبرة ولا خيال ولا تأهيل وتعليم عميق، يحول المنافقون خطاباتهم الجوفاء إلى خطط عمل، ويضع المنتفعون كل القرار في أيديهم، جعلوا بلادنا تسير من وعكة إلى أخرى، حتى وصلنا إلى ما نحن.فيه.